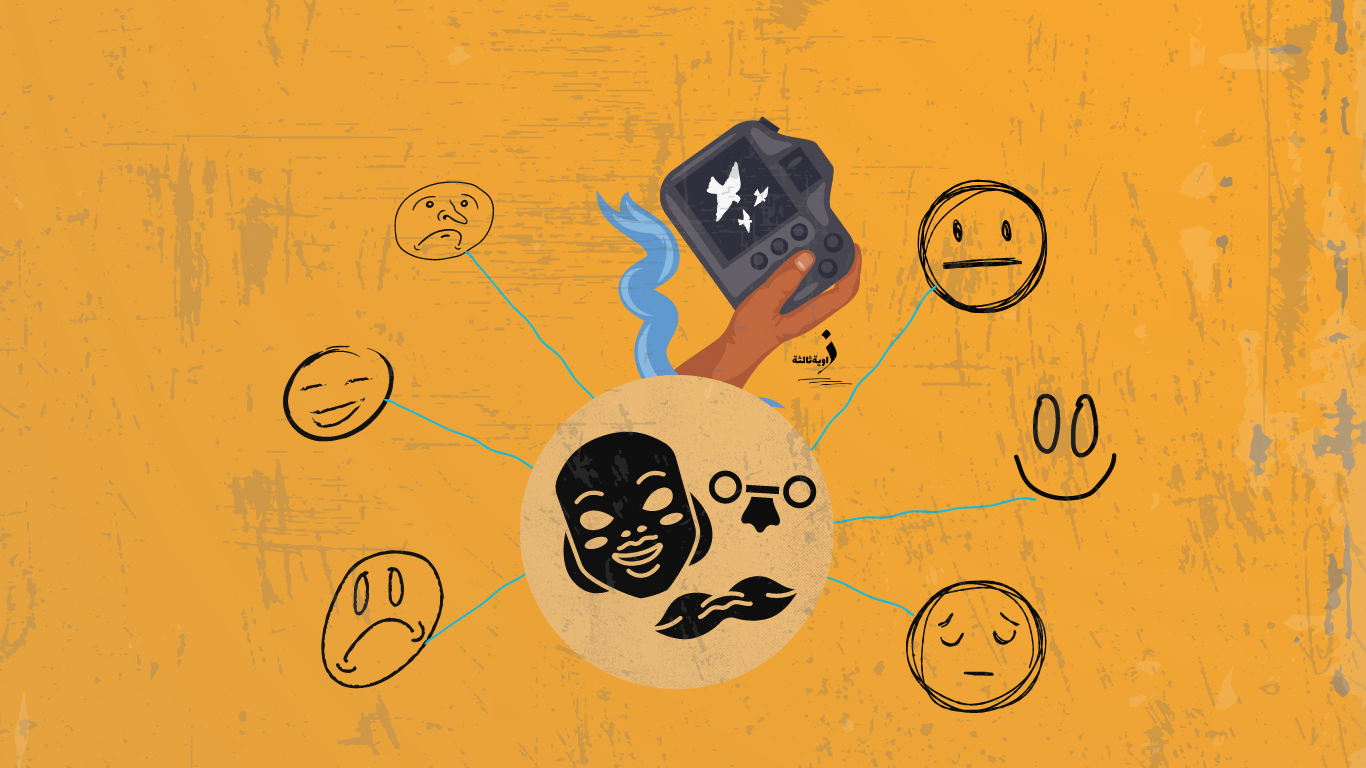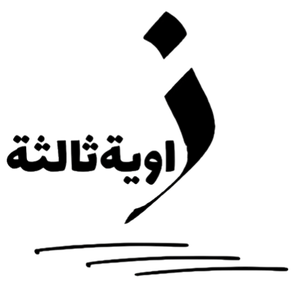إنّ أنسب مدخل للحديث عن ذكرى ثورة 25 يناير، هو أنّ تأْريخ تلك اللحظة ارتبط بتَاريخ دعوات التظاهر، ليس بالنتائج الّتي ترتّبت عليها؛ أي أنّها بتعبير “محمّد نعيم” في كتابه “تاريخ العصاميّة والجربعة”؛ «تسمّى بثورة يناير، أي أنّها مؤرّخة بلحظة اندلاعها، وليس بلحظة سقوط حسني مبارك»، تضعنا تلك الملاحظة البسيطة أمام عقبة فصل الحدث عن النتائج في عمليّة تأريخ ما بعد الثورة، حيث يقلّل من شأن اعتبار المآلات الّتي أدّت إلى إحياء الدولة الوطنيّة القمعيّة في صورة “الجمهوريّة الجديدة”، كونها امتداد للثورة، وليس انفصالًا عنها، بمعنى أنّه فيما تبدو ذكرى “الثورة” في مخيّلة الثوّار، وكأنّه حدث قد تسامى عن سياقه التاريخيّ، وانفصل عمّا بعده.
فإذا كان تشكّل ذاك الحدث الثوريّ نتاجًا لعقود من التفسّخ على عدّة مستويات سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة، بحيث أنّها أخرجت جلّ الصراعات على السطح، ممّا جعل تقويض بنية ووظيفة الدولة الوطنيّة الحديثة في وضع الممكن، فأهمّيّة التعاطي مع حدث الثورة لا بدّ أن يرتبط بما كانت تحمله، إذ إنّ الأمر كان بعبارة “عمرو عبد الرحمن” في مشاركته في كتاب “ثورة يناير (رؤية نقديّة)”؛ أنّه «يبدو كلّ شيء حتميًّا، بقدر ما يبدو كلّ شيء ممكنًا».
لذا تكون ثورة يناير من المعطيات الرئيسيّة والجوهريّة في فهم وتأريخ حقبة “الجمهوريّة الجديدة” المتخيّلة، فمن هذه الزاوية، نحاول طرح تساؤلات بعينها، كيف ساهمت “ثورة يناير” في وضع اللبنة الأولى لمصر السيسي؟ ولماذا تحوّلت الثورة إلى “شبح” يحوم حول الجمهوريّة الجديدة؟ وهل يكون الطريق إلى الديموقراطيّة مشروطًا بإعادة التفكيك والنقد للثورة المصريّة؟
ثورة الجميع: مسارات متقاطعة
تحت وطأة الحكم مبارك الذي سيطر عليه العقلية الأمنية الحديثة، والذي رغم تمكنه أن يحكم مصر ثلاثين عاما، إلا إنه وجد نفسه يتجه صوب الهاوية لعوامل عديدة، أبرزها تململ البيروقراطية العسكرية أمام مشروع توريث مبارك الابن، والذي حمل توجهًا مباشرًا في السماح للطبقة البرجوازية في المشاركة على مقربة من السلطة لأول مرة منذ تأسيس الدولة الوطنية، مما أصاب الخيال السياسي والعسكري للدولة بقلق فقدان البيروقراطية العسكرية فاعليتها ومكانتها كلاعب رئيسي في إدارة المصالح ومشاريع التنمية الوطنية والحفاظ على الاستقرار الجيو استراتيجي. كما أسهمت تلك التغيرات في العقد الأخير في حكم مبارك، إلى بلورة نشاط الحركة المدنية بتياراتها، فيما بدا أن تطلعات نخبتها كانت محدودة بآفاق موقف الجيش في المعادلة السياسية، كما تأسست الحركات والتنظيمات الشبابية وفقا للمطالب الاحتجاجية، وليس على نمط التنظيمات الثورية الكلاسيكية التي تتوغل في حركة اجتماعية وسياسية واسعة تهدف وتحمل مشروعا بديلا للسلطة.
إنّ العوامل الاجتماعيّة من التفاوت الطبقيّ والفساد وغياب التمثيل الاجتماعيّ والحزبيّ والنقابيّ لمصالح الطبقات العاملة، وتهازل الطبقة الوسطى، من مقوّمات الثورات الأساسيّة، فالثورات تندلع في ظلّ أوضاع مخلخلة يشهدها النظام السياسيّ والاجتماعيّ، فلم يعان نظام مبارك اجتماعيًّا من تراخي القبضة الأمنيّة، بل كان الضعف في الجانب الأدبيّ الأيديولوجيّ، بتعبير المفكّر والمؤرّخ المغربيّ “عبد اللّه العروي” في كتابه “مفهوم الدولة”، إذ إن تراجع نظام مبارك كان نابعًا عن العجز في توسيع نطاق الهيمنة الطوعيّة من الدمج والاستيعاب لشرائح وفئات وقطاعات ساخطة ومتضرّرة بشكل فاق الاحتمال، أو مع التصدّع النسبيّ الداخليّ في الولاء وعدم الرضا عن الأداء الحكوميّ ومشروع التوريث. مع ذلك لم يكن حجم السخط المتصاعد في السنوات الأخيرة من حكم مبارك، كفيلًا بالدفع إلى بلورة حركات اجتماعيّة واسعة؛ ممّا جعل الآفاق السياسيّة للبدائل محدودة ومكبّلة للغاية.
يبدو بشكل أو بآخر، أنّ العوامل السياسيّة والاجتماعيّة قد ناسبت هيمنة حركات الإسلام السياسيّ، وبالأخصّ استمرار تنظيم الإخوان المسلمين في الوجود بقوّة رغم التحكّم الأمنيّ، بالطبع كان صعود الإسلام السياسيّ وتوغّله في النسيج الاجتماعيّ في إطار الصحوة الإسلاميّة في المنطقة، ومنوطًا بتساهل النظام وتماهيه مع انخراطهم وسيطرتهم في النقابات المهنيّة والطلّابيّة، وتوسّعهم في الجمعيّات الخيريّة والأهليّة، ويبدو أنّ مبارك قد يسّر توسّع السلفيّة الوهّابيّة في سياق التحالف المصريّ السعوديّ، ليضمن تحجيم نطاق خطاب الإخوان، ويجعل سلفيّة “الجامع” قوّة منافسة للجماعة اجتماعيًّا في المساجد والجمعيّات الأهليّة، ففي التحليل الأخير، أنّ استفادة الدولة من الدور الاجتماعيّ للجماعات الإسلاميّة كان لعبًا بالنار.
وارتأى العديد من المحلّلين والمراقبين أيضًا، أنّ وجود الإسلام السياسيّ كان ورقة سياسيّة هامّة في الداخل للترهيب من فوضى الثورة وخطر الإخوان، وللخارج كمعبّر عن الضغط في إطار الأمّة العربيّة الإسلاميّة، وفي رسالة للإطار الدوليّ وخاصّة الأمريكيّ في ظلّ فترة “الحرب على الإرهاب” أنّ استمرار مبارك هو أنسب للاستقرار من البديل الإسلاميّ.
من جانب آخر، كانت قوّة تنظيم الإخوان تتّسع في القواعد الشعبيّة والاجتماعيّة، على مبدأ «علانيّة الدعوة وسرّيّة التنظيم» والّتي أصلت في الثمانينيّات على يد “حسين علي جابر” في كتاب “الطريق إلى جماعة المسلمين”، لكنّ ما يبدو أنّ الجماعة افتقرت إليه هو الكفاءة والمخيال السياسيّ، بخلط ما هو دعوى وما هو سياسيّ، فبحسب نائب المرشد السابق “محمّد حبيب”: “نحن للأسف نرشّح الشخصيّات الجماهيريّة والّتي لها ثقل دعويّ، ولا تصل للسياسة.”، وذلك وضّح جليًّا في الفترة الإنتقاليّة، وفي ظلّ حكم الرئيس السابق محمّد مرسي.
“الجيش والشعب إيد واحدة” ذاك الهتاف هو شعار يكفي للدلالة الرمزيّة على موقع الجيش في بنية الدولة الوطنيّة الحديثة، إذ اعتبر الجيش الوطنيّ هو فاتح الطريق إلى الثورة، لأيّ حركة شعبيّة ثوريّة في سياق الدولة العربيّة، ولم يكن ما حدث في خضمّ الثورة والفترة الانتقاليّة ببعيد عن آفاق النظريّات، ففي كتابه الموسوعيّ “تضخيم الدولة العربيّة” يتناول المفكّر المصريّ “نزيه الأيّوبي” العلاقة بين المدنيّة والعسكريّة في مصر، بعين ثاقبة في قراءة بنية الدولة والمجتمع، حيث أفاد؛ أنّه إذا قدّر لانتفاضة شعبيّة أن تحدث، فإنّ هنالك احتمالين غير احتمال تدخل الجيش لإعادة الأمور للسلطة كما حصل في ١٩٧٧ و١٩٨٦، وهما: أنّ القيادة العليا قد تتولّى السلطة بذريعة استعادة القانون والنظام، أو يمكن أن تعقد صفقة بين أطراف من العسكر وأطراف من الحركة الإسلاميّة.
يبدو أنّ كلا الاحتمالين قد حدثا معًا بشكل يتناسب مع المجريّات، فما نشر من “مذكّرات الفريق سامي عنان”، الّتي تفيد اقتراحه للمشير طنطاوي بالقيام بانقلاب ناعم، بوازع وطنيّ للحفاظ على بنية الدولة، وهو فيما يبدو ما آلت إليه الأمور في نهاية الأمر، هو الضغط على “مبارك” حتّى تمّت التسوية، من ثمّ تولّي القيادة العسكريّة البلاد في مسار آمن على طريقة العقليّة الأمنيّة البحتة، كان الهدف الحفاظ على الدولة والسماح بإصلاح دولابها العميق بقدر أشدّ محافظة على الأوضاع، لا يؤثّر في حماية المصالح الداخليّة والإقليميّة للبيروقراطيّة العسكريّة، وذلك فيما يبدو مثل عقبة في النجاح الكامل للصفقة بين الأطراف العسكريّة والإسلاميّة، والّذي أفرزت بطلها الخاصّ، وهو “مدير المخابرات الحربيّة” الّذي عيّن وزيرًا للدفاع “بنكهة الثورة” بعنوان بوّابة “الحرّيّة والعدالة” الشهير.
هنا كان مسار “السيسي” ممهّدًا يومًا بعد يوم، فما ذكره الصحفيّ “ياسر رزق” في كتابه “سنوات الخمّاسين” بأنّ المشير “طنطاوي” بدا أنّه يؤهّل الجنرال الشابّ “عبد الفتّاح السيسي” في مستقبل قريب قائدًا عامًّا للقوّات المسلّحة، ولعلّه كان ينظر إليه كخليفة له في القيادة. يدعنا للقول إنّ حدثًا ضخمًا مثل ثورة يناير، مثّلت وضعًا مناسبًا لأن يثبت فيها الجنرال الطموح، قدرته على حماية أركان “الدولة” بنيّتها من أيّ مشروع لا يتوافق مع تفرّد المؤسّسة العسكريّة وعقيدة التحفّظ الأمنيّ.
بيد أن تباهي الثورة المصريّة بتنوّع مكوّناتها وتيّاراتها، كان خادعًا وطارئًا، كما كان مثيرًا للإعجاب، حيث إنّ المسارات الّتي تقاطعت في لحظة يناير، وأفرزت شعارات عامّة وفضفاضة، كان لكلّ منها مسار ا نهائيًّا، لتطلّعات كلّ طرف على ضوء المعادلة السياسيّة، فكانت يناير متباينة الهويّة على حسب كلّ طرف، إمّا كونها انقلاب عسكريًّا ناعمًا/ أبيض، أو أنّها ثورة إسلاميّة، أو ثورة مدنيّة ليبراليّة، إمّا ثورة شعبيّة واجتماعيّة! وحتّى عندما بدت فيه الثورة أنّها للجميع لا لأحد، رغم ذلك لم تنجح في تسوية بين علاقة الأطراف والمراكز وفق المصالح المشتركة الّذي بدا ممكنًا.
لكن فيما يبدو أنّ العامل البنائيّ ثقافيًّا واجتماعيًّا كان عائقًا عن التقدّم بعيدًا عن الحلول الإقصائيّة، حيث إنّ الثقافة العسكريّة الأمنيّة مرتبطة بمفهوم الدولة الوطنيّة وشائعة في مقولات شعبيّة، كما أنّها متناسبة مع تراث الاستبداد اجتماعيًّا وثقافيّة وسياسيًّا بداية من السلطة العائليّة إلى الدولة شديدة المركزيّة، وأنّ الجماعات الإسلاميّة الحديثة رغم تنوّع تيّاراتها في المجتمع والسياسة، إلّا أنّ الأيديولوجيا الإسلامويّة لا تستقيم غير مع السعي للهيمنة عن طريق الإيمان الدينيّ، كما أنّ البرجماتيّة الإصلاحيّة الإخوانيّة لم تعوّض فقر الخيال والفاعليّة السياسيّة، أمّا التيّارات المدنيّة المختلفة لم تجد بدًّا سوى التواطؤ أحيانًا مع العسكريّين أو الإسلاميّين، في ظلّ غياب المشروع السياسيّ المدنيّ، وبما تفقده من القواعد الشعبيّة الراسخة، وسارت الحركات الشبابيّة تبلور المثاليّة الرومانسيّة بشكل يتسامى في أغلب المواقف عن الواقع الحاصل.
تاريخ الثورة: كيف تحوّلت “الذكرى” إلى شبح الجمهوريّة الجديدة؟
لا بدّ من القول إنّ الثورة المصريّة عبّرت عن تضخّم أزمة المجتمع والدولة معًا، لكنّها بشكل أو بآخر لم تكن خروجًا على قواعد الدولة الوطنيّة وبنيتها المفاهيميّة والهيكليّة ولا على إطار القيم الاجتماعيّة المحافظة، لذا لم تكن الحلول والأهداف التغييريّة الّتي رفعت باسم الثورة، سواء من الإخوان المسلمين، أو من الثوّار المدنيّين فاعلة في التأثير والتفاوض مع تلك البنية من أجهزة الدولة العميقة، فربّما أوصلت الثورة حركات الإسلام السياسيّ إلى أوج صحوتها، حيث تمكّنت من التعبئة والحشد والتفاوض، والّذي أسهم في نجاح أحد أكبر تيّاراتها “الإخوان” إلى سدّة الحكم، وذلك كان كفيلًا ليوضّح أنّ فكرة الثورة عند الأيديولوجيّة الإخوانيّة مغايرة مع مفهوم الثورة لدى القطاعات المدنيّة، وكلاهما يهدفان إلى الانتقال بالدولة الوطنيّة إمّا للصبغة الإسلاميّة أو بالديموقراطيّة السياسيّة المحافظة، أمّا مفهوم الثورة الشعبيّة لدى العقيدة العسكريّة السائدة، فيبدو أنّها كانت مركّبة بعض الشيء، فمن جانب أنّ الانتفاضات مناخ يسوده بعض من الاضطرابات والفوضى؛ ممّا يهدّد الأمن العامّ، ولكنّها تمثّل أيضًا في الوقت نفسه، فرصة سانحة للطموحات والرؤى الإصلاحيّة داخل الدولة العميقة، لا سيّما البيروقراطيّة العسكريّة، الّتي تهدف إلى إنعاش الدولة وتصحيح مسارها عبر كسب التأييد الشعبيّ.
ما يجعل القول ممكنًا، في أنّ الجمهوريّة الجديدة هي بالأخير محصّلة مبكّرة لثورة يناير، هو النظر إلى التاريخ باعتباره “موضوع رهان صراع تاريخيّ” بتعبير عالم الاجتماع الفرنسيّ “بيير بورديو”، وذلك ما يفسّر أنّ المنتصر يسعى دائمًا في تسييد روايته بما تحملها من تصوّرات ومقولات، وذلك ما تبديه خطابات “الجمهوريّة الجديدة” في محاولة سرد تاريخ الثورة حصرًا في مظاهر الأحداث المضطربة! فعلى الرغم من اعتراف السلطة بشرعيّة ثورة 2011م وامتدادها في 2013م، لكنّ ما تكرّر كثيرًا على ألسنة السلطة، تلميحًا بأنّ ثورة يناير “المشروعة” كانت محاطة بالمؤامرات الّتي تهدف إلى هدم الدولة، كما يحمل الحدث أيضًا التبعات الاقتصاديّة والتنمويّة الفاشلة بغضّ النظر عن الأسباب والعوامل الّتي أدّت إليها.
لا يبدو ذلك الخطاب مخادعًا بقدر ما هو معبّر عن قناعة راسخة برؤية تبدو شديدة التبسيط والاختزال، ففيما يبدو أنّ استخدام التاريخ بطريقة تخدم سرديّة الدولة الجديدة، ليس موجّهًا للشعب والرأي العامّ فقط، أكثر ما هو موجّهًا إلى دوائر المصالح والمحاسيب الداعمة لاستكمال السلطة لاستقرار أعمالهم، كما هو يعدّ قلقًا متكرّرًا من تعقيد الدولة العميقة، فإذا كانت الثورة جزءًا مكوّنًا لطريق الجمهوريّة الجديدة، فما يظهر أنّ ذاك التاريخ أصبح شبحًا قابعًا في مخيّلة السلطة. وبدأ ذلك مبكّرًا في تحويل ذكرى الثورة، إلى قبضة أمنية تهدف إلى رسوخ القمع وبناء جدار عال من الخوف مجدّدًا.
بعد ما بعد الثورة: هل تنتقل “الجمهوريّة الجديدة” إلى الديموقراطيّة؟
ترجع أسطورة “البلد تحتاج إلى رجل عسكريّ”، إلى تاريخ تبلور الأمّة المصريّة الحديثة، حيث لعبت العسكريّة دورًا مركزيًّا في الحياة السياسيّة، فالوعي الوطنيّ المصريّ ناشئًا على ثورة عرابي، والجمهوريّة الأولى تأسّست خلال حركة الضبّاط “الأحرار” ذوو بعد وخلفيّة سياسيّة متراكمة خلال فترة الملكيّة وثورة 1919م، وعلى الرغم من أنّهم بشكل ما أبناء تلك الحياة السياسيّة وأحزابها، إلّا أنّ الأوضاع تشكّلت على تغيّرات جذريّة في بنية المجتمع والدولة وطبيعة الإنتاج، حيث اعتبرت “الشخصيّة” العسكريّة كمثال على الانضباط والكفاءة والشرف والوطنيّة، ومثّلت كاريزما “عبد الناصر” ودهاء “السادات” وجدانًا وإرثًا متناقلًا، والمفارق أنّ الهزيمة والنصر كلاهما رسخا صورة “البطل” في الوعي الشعبيّ في ظلّ حالة الحرب والسلام.
بيد أنّ تلك الصورة العالقة في الأذهان، تُستدعى شعبيًّا في وقت الأزمات، حيث إنّ وظيفة الالتحاق للجيش تعدّ أسمى صور مفهوم الوطنيّة المجسّدة، حيث سعت المؤسّسة العسكريّة إلى عدم التسيّس داخل المؤسّسة، رغم ذلك.. عندما يلوّح بقرار القيادة العسكريّة لإنقاذ الأوضاع من التدهور أو خطر نشوب اقتتال داخليّ، تستلهم مشاعر الوطنيّة حصرًا، ويغضّ النظر عن مدى ارتباطها البنيويّ بالسلطة والسوق، فتحوذ مكانة الوصاية على الحياة السياسيّة وإعادة إنتاج إخضاع المجتمع وتوجيهه.
اصطدمت ثورة يناير بتلك البنية الشعوريّة والمفاهيميّة، لكنّ هذه الفاعليّة ظلّت وقتيّة وعابرة، حيث إنّ إرادة الفاعليّين الثوريّين تتوقّف على مدى ملائمة مساراتهم ونظريّاتهم مع الشروط الموضوعيّة للسياق التاريخيّ والاجتماعيّ، إذ كانت الدولة الحديثة قد همشت المجتمع لصالح تضخّم مؤسّساتها، فلا معنى في الحديث عن التغيير إلّا بإعادة المجتمع إلى المعادلة، والّذي لا يتسنّى له ذلك إلّا عبر انفتاح الرؤى الثوريّة على بقاع الأطراف والهوامش الاجتماعيّة بشكل عميق في الفترات الراكدة، فإنّ المفارقة الواضحة الّتي شهدتها أيّام الثورة، حين كانت الميادين تعجّ بالمتظاهرين، والبائعين أيضًا، ممّا يلفت انتباهنا إلى الشرائح محدودة الدخل، إذ كان جلّ اهتمامهم في الاستفادة الجيّدة ممّا يحصل، وحتّى عندما طالهم ما طال المتظاهرين من رصاص وقمع، وتجمّع الباعة الجائلين في نقابة تمثّلهم كان مظهرًا ثوريًّا اجتماعيًّا، لكنّه في الأخير ترك لمصير التأقلم مع السيطرة الأمنيّة.
إنّ نقد تاريخ الثورة قائم على محاولة النفاذ إلى مسارات الممكنات الّتي لم تدرج تحت أفق الفاعليّين السياسيّ المحدود بلحظتها، إذ إنّ مهمّة تفكيك مفهوم الإنقاذ “العسكريّ” لصالح تنمية الشعور الجمعيّ نحو أهمّيّة المجتمع وقواه، يأتي مع تعزيز الممارسة الديموقراطيّة في نطاق أوسع عبر الولادة العسيرة والمضنية للمجتمع المدنيّ من خلال تنظيماته المختلفة، النقابيّة والمهنيّة والطلّابيّة والحقوقيّة والحزبيّة… إلخ، حتّى في ظلّ حصار المجال العامّ، لكنّها تظلّ في دائرة الممكن.
هكذا يعدّ تشكيل مفهومًا “للإنقاذ” على نحو مدنيّ مجتمعيّ، هو نقد ممتدّ للثورة وللدولة الحديثة معًا، حيث إنّ نموذج الحداثة المصريّ، كان دائمًا منذ محمّد علي إلى عبد الناصر متّكئًا على التغيير من الأعلى، حتّى فيما يبدو أنّ ثورة يناير كانت تطالب بأهدافها كي تمرّر التغيّرات من أعلى إلى أسفل، وذلك ما يدعونا إلى إعادة التفكير الأفقيّ الاجتماعيّ، وفي تعزيز الممارسة الديموقراطيّة بين المجموعات الّتي تهدف إلى إرساء حياة سياسيّة مدنيّة تشاركيّة وتنافسيّة، إنّ التدفّق والممارسة لها أوجه وطرق متنوّعة، غير محصورة في الهتاف الثائر دون الوقوف على أرض ثابتة. فإنّ التغيير يشترط المعرفة والعمل معًا. ولذلك هناك أوجه كثيرة تجعل السلطويّة قائمة وقادرة على إعادة إنتاج نفسها ما دامت مبرّراتها وبنيتها حاضرة.
إنّ نقد تجربة ثورة يناير، إنّما هو تفكيك لإطارات مفاهيميّة عديدة، تقوم عليها مؤسّساتنا ومخيالنا، تصل إلى مفاهيم الأمّة والوطنيّة ومحمولاتهما الاستبداديّة. إذ كان المجتمع غير مؤهّل للديموقراطيّة، كما قال اللواء “عمر سليمان”، فإنّ ذلك يقع على عاتق ومسؤوليّة الدولة الحديثة بالطبع، لكنّه أيضًا بمشاركة من مفهوم الثورة المتخيّل عن طرق التغيير.