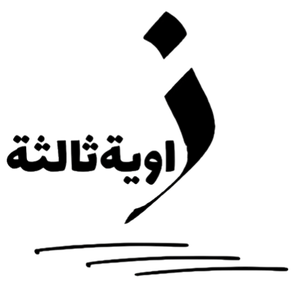الرأي السائد لدى قطاعات ليست بالقليلة من المصريّين بشأن ثورة 25 يناير 2011، الّتي أطاحت بحكم الرئيس الراحل حسني مبارك الّذي استمرّ 30 عامًا، أنّها السبب الرئيسيّ والمباشر فيما وصلت إليه أحوال البلاد. بات هذا الرأي يزداد رُسوخًا لدى العامّة كلّما اشتدّت الأزمة الاقتصاديّة، وكلّما أصبحت الحياة أكثر صعوبة وقسوة. ساعد على ترسيخ هذا الاعتقاد الّذي يرقى لدى البعض إلى مستوى الحقيقة الإيمانيّة الّتي لا تقبل نقاشًا أو فحصًا، ما آلت إليه انتفاضات عربيّة أخرى، لاسيّما في اليمن وليبيا وسوريا. وإذا أضفنا الوضع في العراق والسودان، وما تُواجهه مصر من تحدّيات تتعاظم يومًا بعد آخر، يُصبح الدفاع عن انتفاضة الشعوب العربيّة من أجل الحرّيّة والكرامة الإنسانيّة ضربًا من الجنون.
لا بأس.. لنمارس بعض الجنون، لعلّنا نجد في ذلك حكمة ما، أو لعلّنا في نوبة من نوباته نرى مشاهد غابت عنّا في غمرة الأحداث المتلاحقة، تنير لنا طريقًا للمستقبل، ولعلّنا نرى مشاهد أخرى تساعدنا على تفسير ما حدث ولماذا انتهينا إلى الوضع الراهن، ولعلّنا إمعانًا في الجنون أن نصرخ في وجه من أوصلونا إلى هذا الوضع قائلين: كفى؛ أملًا في أن تكون صرخة في أوانها تنبّه الغافلين إلى ضرورة تصحيح المسار قبل فوات الأوان.
لقد جاءت الأحداث بعد تنحّي مبارك متلاحقة ومتتابعة، ومُورست كلّ ألعاب السلطة من أجل الحفاظ على الجوهر الصلب للنظام، ذلك الجوهر الّذي يحلو للبعض تسميته “الدولة العميقة”، وهي من المسمّيات الّتي ألقيت كي يتشدّق بها الخاصّة والعامّة دون إدراك لمدى فراغ هذا المصطلح وخلوّه من المعنى والدلالة، تمامًا مثل مصطلحات كثيرة تمّ تداولها وردّدتها الأفواه، مثل “الفلول” و”الإسلام السياسيّ”، وسقطنا صرعى ألاعيب من قبيل “الانتخابات أوّلًا أم الدستور أوّلًا”، وجرى تخدير شباب الثورة منفردين وعبر ائتلافات تشكّلت وانفضّت، بتعظيم إحساس هؤلاء البرجوازيّين الصغار بنشوة “انتصار الزائف” في ثورة أريد تزييفها. ليظلّ تزييف الوعي الآليّة الرئيسيّة الّتي تضمن للسلطة البقاء في موقعها، إدراكًا منها لأهمّيّة الوعي لكسب المعركة.
الافتقار إلى أفق معرفيّ
كتبَ الكثيرَ عنْ الثورةِ المصريةِ وعنْ انتفاضاتٍ أخرى في إطار ما أُطلق عليه “ثورات الربيع العربيّ”، تيمّنًا بالثورات الّتي اندلعت في مواجهة الاستبداد السوفياتيّ في بلدان شرق ووسط أوروبا في العقود الخمسة الأخيرة من القرن المنصرم. ولمْ يلتفتْ أحدٌ إلى إشارةِ البعضِ إلى أنّ “الربيع العربيّ” ما هو إلّا “شتاء إسلاميّ”، وما تحمله تلك الإشارة من مدلولات ترسم ملامح الثورة المضادّة الّتي أريد لها أن تزيح الثورة الأصليّة بارتداء مسوحها، إلى أن تحين لحظة الانقضاض عليها تشهيرًا وتجريجًا وطعنًا، والتمهيد لإعادة تأسيس جمهوريّات للخوف لم تعد تخيف أحدًا.
إنّ إطلاق وصف “الثورة” على ما حدث في 25 يناير 2011، وما تبعه حتّى تنحّي مبارك وما تلاه من إدارة شؤون البلاد جرى تسليمها للمجلس الأعلى للقوّات المسلّحة، ما هو إلّا تأكيدًا لاستمرار النظام، وأنّ التغيير طال رأس السلطة فقط، ولم يدخل تعديلاتٍ جوهريةً على قواعدِ اللعبةِ الّتي وضعت بإتقان خلال حكم مبارك الّذي امتدّ ثلاثة عقود، والّذي دعا كثيرًا من المراقبين الأجانب الحصيفين يتحدّثون على مدى آخر عامين في حكم مبارك على أنّ مصر مقدّمة على مرحلة جديدة من الحكم أطلقوا عليها “المباركيّة بدون مبارك”، وهو تعبير يدلّ على قراءة جديدة للتحوّلات الّتي أدخلها مبارك في أسلوب حكمه، والّتي تتعامل مع عدد من الحقائق أبرزها اغتيال الرئيس أنور السادات بما يحقّق استقرار نظام لا يمتلك القدرة اللازمة للتعامل مع استراتيجيّات الصدمة الّتي ينتهجها السادات، لكنّ جانبًا من الأسس والقواعد الّتي اعتمد عليها مبارك وضعت في عهد السادات في سياق الصراع على السلطة.
كثير من الحقائق المتعلّقة بتحوّلات السلطة في مصر كان غائبًا عن الشباب الّذين أخذوا زمام المبادرة في 25 يناير 2011، عبر مظاهرات اختاروا أن تكون في يوم احتفال الشرطة المصريّة بعيدها، الّذي هو مناسبة وطنيّة وبحقّ، بالتذكير بطبيعة التحوّلات الّتي جرت في علاقة الشرطة بالشعب، والّتي تجاوزت في التنكيل بالناس حدودًا لم تعد مقبولة، بسبب الدور الّذي اختارته النخبة الحاكمة للهيئة المدنيّة المعنيّة بالحفاظ على النظام العامّ وتوفير الأمن للمواطنين. إنّ من يتأمّل الشعارات الّتي رفعها المتظاهرون أيّام 25 و26 و27 يناير والأساليب الّتي اتّبعوها، ويقارنها بما حدث بعد “جمعة الغضب” يوم 28 يناير، يجد فجوات كثيرة مليئة بالأسئلة الّتي لم يتوقّف أحد أمامها، ومن ثم لم تجد إجابة في حينها، ولو توافرت تلك الإجابات لاتّخذت الأحداث التالية مسارًا مغايرًا، وكان من الممكن أن يكتب النجاح لطليعة الثوّار، إذا وجدت في إعادة كتابة مستقبل مصر.
هناك شروط من الضروريّ توافرها لوصف أيّ حدث بهذا الحجم بأنّه “ثورة” في مقدّمة هذه الشروط “الطليعة الثوريّة” أو “الحزب الثوريّ”، فهل وجد في مصر في ذلك الحين هذه الطليعة وذلك الحزب؟ سؤال علينا أن تفكّر في الإجابة عنه بمنتهى الشفّافيّة والصراحة كي لا نستمرّ في خداع أنفسنا. الشرط الثاني، يتعلّق بالقاعدة الاجتماعيّة أو القوى الاجتماعيّة الداعمة لهذه الطليعة والّتي تتبنّى مشروع الثورة، هل يمكن لنا أن نحدّد ما هي القوى الاجتماعيّة الحاضنة للثورة والساعية للتغيير؟ أعتقد أنّ الإجابة عن هذا السؤال لا تقلّ مراوغة عن الإجابة عن السؤال السابق، ولعلّ أحد الأسباب لذلك هو إمعاننا في عدم التدقيق في المصطلحات والمفردات الّتي نستخدمها في لغتنا السياسيّة، عندما أطلقنا على انقلاب مجموعة من ضبّاط الجيش ليلة 23 يوليو 1952، على النظام الملكيّ “ثورة”، وخلطنا التغييرات الاجتماعيّة الجذريّة الّتي أحدثها الحكّام، والّتي كانت لاحقة على الحدث، والّتي تندرج في سياق برامج للهندسة الاجتماعيّة الّتي تستهدف بناء قاعدة اجتماعيّة جديدة للنظام الجديد، وبين التغييرات الثوريّة الّتي كانت تمضي في طريق آخر تبيّنه الكتابات عن الحالة السياسيّة والاجتماعيّة الّتي كانت فيها مصر منذ عام 1930، والّتي تبلورت مع تزايد حدّة التناقضات الاجتماعيّة والأيديولوجيّة في عام 1945، والّتي رصدها ببراعة المستشار طارق البشري في كتاباته وأشهرها كتّاب الحركة الوطنيّة المصريّة، إذا قرأناها بمعزل عن تحوّلاته الفكريّة وتحيّزاته الحزبيّة اللاحقة.
الشرط الثالث الّذي غاب عن انتفاضة 25 يناير لا ينفصل عن الشرطين السابقين، بل إنّ توافره عنوان لوجودهما وغيابه تأكيد لغيابهما، هذا الشرط هو امتلاك رؤية جديدة للعالم ولمصر، مصر الأخرى الّتي في ذهن الطليعة الثوريّة، والّتي تستجيب لتطلّعات القوى الاجتماعيّة الساعية للتغيير الجذريّ. هذه الرؤية تعبّر عن طبيعة الأفق المعرفيّ للطليعة الثوريّة الّتي من المفترض أن تقود الجماهير على طريق التغيير الجذريّ، بعد أن بلغ مشروع الإصلاح الّذي تطرحه النخبة الحاكمة إلى طريق مسدود؛ بسبب احتدام الصراع على السلطة، على خلفيّة مشروع التوريث الّذي كان يتردّد في بعض أروقة السلطة والّذي كانت تنخرط فيه أجنحة من السلطة، لم تكن هي أيضًا متّفقة على الهدف والرؤية، وهي مسألة كانت جليّة في طبيعة التحالف الّذي كان داعمًا لنقل السلطة من مبارك الأب إلى مبارك الابن. هناك شروط أخرى تعطي لهذه الثورة أو تلك طابعها، لن نتطرّق إليها في هذا المقال.
الثورة المضادّة الممتدّة
لا يمكن فهم ما حدث في 25 يناير 2011، وتداعياتها بمعزل عن فهم ما حدث في التاريخ المصريّ الحديث وإعادة قراءته قراءة واعية، ليس من أجل الإغراق في الماضية أو سعيًا لاستعادة عالم انتهى، وإنّما لفهم المسار العامّ، وإلى أين ستأخذنا التناقضات الراهنة في المستقبل القريب. وكيف يمكن أن يكون للقوى الاجتماعيّة المختلفة دور في صنعه. ونقطة الانطلاق في هذا الفهم هي الإجابة عن السؤال لماذا هزم مشروع التغيير في مصر، وانتصر مشروع الثورة المضادّة وثبّت أقدامه، وكيف استفادت هيئة أركان النظام من تناقضات جرى زرعها في عقود سابقة وأحسن توظيفها؟
ولا يمكن فهم ذلك دون تحليل لطبيعة التناقض الرئيسيّ الحاكم للصراع الاجتماعيّ والصراع السياسيّ في مصر وتمييزه عن تناقضات كنّا نظنّها رئيسيّة، لكن ثبّت بالدليل القاطع أنّها كانت ولا تزال وستظلّ تناقضات ثانويّة يمكن الدفع بها مرّة أخرى في صدارة المشهد إذا احتدمت التناقضات الرئيسيّة إلى حدّ يهدّد أركان النظام وقواعد سلطته. التناقض الثانويّ هنا والّذي يجري تصويره، عند الحاجة باعتباره تناقضًا رئيسيًّا، هو ذلك التناقض المزعوم بين النظام القائم منذ عام 1952، وبين مشروع الإسلام السياسيّ كما تعبّر عنه جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة رسميًّا، باعتبارها الأصل والمشروع الأمّ الّذي ولدت من رحمة كلّ تيّارات الإسلام السياسيّ الأخرى، السلفيّة منها والحداثيّة.
إنّ نظرة مدقّقة وفاحصة ونقديّة لأيديولوجيّة النظام الحاكم وسياساته كفيلة بإسقاط هذا الوهم الّذي تستسيغه البرجوازيّة الصغيرة في المدن؛ بسبب وضعها الاجتماعيّ القلق وطابعها القيميّ المحافظ.
إنّ استمرار هذا الوهم هو الّذي يجعل تلك الطبقة الاجتماعيّة الّتي تشكّل الركيزة للنظام تتقلّب بين ثنائيّة العسكر والإخوان، ولم تستطع بلورة تيّار ثالث يكسر هذه الثنائيّة ويتجاوزها. هذه الطبقة الاجتماعيّة هي الحاضن الرئيسيّ والضامن لاستقرار النظام بوجهيه، العسكريّ والأصوليّ، وهي مستمرّة في لعب هذا الدور، بالرغم من أنينها تحت وطأة الإجراءات القاسية الّتي يقدم عليها النظام لضمان بقائه لافتقاره لأيّ مقوّمات للشرعيّة الّتي يقوم عليها الحكم، وعجزه عن إنتاج سياسات تضمن له تعزيز الركيزة الثانية للسلطة وهي رضا المحكومين. وتعوّض السلطة العرجاء والعاجزة هذا النقص من خلال الإفراط في سياسات القمع والتنكيل بالمعارضين، والاستمرار في تأميم العمل السياسيّ من خلال وأد أيّ محاولة جادّة على مستوى بناء التنظيمات السياسيّة وفرض قيود صارمة على التنظيم الّذي هو أساس العمل السياسيّ، والإفراط في استخدام الخطاب الدينيّ، والإسراع لحلّ أيّ تناقض قد يظهر مع المؤسّسة الدينيّة ورجال الدين، ويكمل هذه السياسة بالتلاعب بالتناقضات واستغلالها.
من المؤسف، أنّ السياسة هي الشيء الوحيد الّذي جرى تأميمه في مصر، ضمن ما جرى تأميمه، ولم يرد إلى أصحابها في سياق سياسات الإصلاح الّتي أعادت كثيرًا من الممتلكات الّتي جرى تأميمها وسياسة خصخصة المشروعات العامّة الّتي شكّلت الركيزة الاقتصاديّة للنظام. لقد سجّلت مؤسّسة بحثيّة أوروبّيّة بارزة هذه الحقيقة في تقرير نشرته عن مصر في أعقاب حرب العراق عام 2003، أشارت فيه إلى الافتقار إلى حياة سياسيّة تتوفّر لها مقوّمات البقاء، ويمكن التعويل عليها في هذا الركن من العالم، على الرغم من وجود انتخابات وتيّارات معارضة وأحزاب سياسيّة. إنّ هذا المشهد الخادع الّذي جرى توظيفه في إدارة المرحلة الانتقاليّة، وفي سلسلة الانقلابات المتتالية بدءا بالانقلاب الّذي أعلنه الشيخ يوسف القرضاوي في خطابه في ميدان التحرير في 18 فبراير 2011، أي في الجمعة التالية على جمعة خطاب تنحّي مبارك، وجرى تكريسه من خلال الاستفتاء على التعديلات الدستوريّة في 19 مارس 2011، ثمّ سلسلة الإعلانات الدستوريّة، وإدارة الصراع على السلطة عبر الانتخابات، هو إحدى ركائز النظام، وسيتسمّر هكذا بعد إعادة ضبطه وترتيبه في أعقاب انقلاب 2013، الّذي جاء تتويجًا لسلسلة الانقلابات عبر إعلانات دستوريّة مكمّلة جميعها يعبّر عن طبيعة الأزمة الناجمة عن الإفلات من الاستحقاق الدستوريّ المؤجّل، والّذي سيستمرّ تأجّليه مع استمرار حكم هيئة أركان الثورة المضادّة.
مفاهيم جديدة للثورة وأفق المستقبل
لقد حدثت ثورة في الثورة، إذ أدخلت الدراسات الّتي أجريت على الثورات في العالم وكذلك الدراسات الّتي أجريت على الدراسات تناولت هذه الثورات مفاهيم جديدة، منها الثورات المدنيّة الديمقراطيّة والثورات الإيديولوجيّة والعقائديّة والثورات الملوّنة، بل دخلت مفاهيم جديدة على آليّات العمل الثوريّ، منها حديث البعض عن ثورات جماهيريّة بلا قادة، الّتي تشير إلى ثورات جماهيريّة أحدثت تغييرات، وأطاحت بأركان النظام الجديد، وتسلّم زمام السلطة قادة لم يكن لهم أيّ دور في الثورة، لكنّهم يمتلكون رؤية لتحقيق الانتقال المنشود في المستقبل. هذه المفاهيم بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة والتطوير بقصد الاستفادة منها لتفسير لماذا حدث هذا الانحراف في مسار الانتفاضات العربيّة، وأدّت إلى أزمات ممتدّة تحول دون تحقّق الاستقرار السياسيّ والاجتماعيّ، كما حدث في ليبيا واليمن، ثمّ حدث لاحقًا في السودان، أو أوصلت المعارضة المسلّحة إلى طريق مسدود مثلما حدث في سوريا.
إنّ محاولة تفسير ذلك المصير الّذي انتهت إليه هذه المشروعات للتغيير تتطلّب إطارًا أوسع للتحليل يأخذ في اعتباره طبيعة التحالفات الّتي نشأت على المستوى المحلّيّ والإقليميّ من قبل القوى المسيطرة الّتي تسعى للحفاظ على الوضع القائم. والمنطقة ليست استثناء في هذا، لقد نشأ مثل هذا الحلف الإقليميّ في مواجهة الثورة الفرنسيّة 1789-1799، وكذلك في مواجهة الثورة الروسيّة الأولى في عام 1905، والثانية في عام 1917، وحدث في منطقتنا من قبل في مواجهة الثورة الإيرانيّة في عام 1979. وأدّت التدخّلات الخارجيّة، لاسيّما التدخّلات المسلّحة الّتي تطوّرت في بعض الحالات إلى الحرب، إلى الانقسامات الداخليّة الّتي أدّت إلى حالات من الفوضى في هذه المجتمعات مع الحفاظ على هياكل شكليّة للسلطة الحاكمة.
وعزّز هذا الحلف الإقليميّ قوى الثورة المضادّة في الداخل بزعم التصدّي لمشروع الإسلام السياسيّ الّذي رأت بعض القوى في هذا التحالف الإقليميّ أنّه الخطر الأكبر على استقرار المجتمعات والدول، وعلى مشاريع التحديث الّتي تنخرط فيها النخب الحاكمة في تلك الدول.
اللافت للنظر هنا، هو أنّ النخب القديمة في تلك الدول المحافظة كانت هي الركيزة والسند لتيّارات الإسلام السياسيّ والتيّارات السلفيّة الرافضة لمشروعات التحديث، والّتي تتطلّع إلى إحياء الخلافة الإسلاميّة. وقد لعبت جماعات الإسلام السياسيّ، لاسيّما السلفيّون دورًا في دعم هذه النظم المحافظة والترويج لها كنموذج من نماذج الحكم المنشود الّذي يتبنّى شعار تطبيق الشريعة الإسلاميّة. إنّ وجود هذه القوى في الحلف الداعم لقوى الثورة المضادّة في المجتمعات الّتي تشهد وضعًا ينذر باحتمالات للتغيير الجذريّ المتصادم مع هذه النظم والّذي يشكّل تهديدًا لها، وإصرارها على التناقض الرئيسيّ هو مع تيّارات الإسلام السياسيّ، يضع مشروع الإصلاح في مأزق، ويساهم هذا الوضع في إحباط أيّ مشروع للتغيير سواء عبر الإصلاح أو عبر الثورة كفعل سياسيّ منظّم لإحداث تغيير جذريّ.
ويعكس التردّي الاقتصاديّ المتزايد وتزايد حدّة التناقضات الاجتماعيّة في المجتمعات العربيّة في زيادة عوامل التفكّك والفوضى الّتي قد تترتّب على انفجار اجتماعيّ عنيف، تتشكّل ملامحه في ظلّ الإصرار على المضيّ قدمًا في السياسات الاقتصاديّة الّتي تزيد مستويات الفقر والجوع في المجتمعات، بينما تتراكم الثروة في أيدي أقلّيّة صغيرة.
إنّ البحث عن مخرج من هذا الوضع البائس إنّما يتمّ من خلال إعادة التفكير في الترتيبات الراهنة للسلطة بمعناها الواسع والتركيز على التناقض الرئيسيّ الفعليّ واتّخاذ ما يلزم من إجراءات للحدّ من احتمالات الانفجار الّذي لا يعلم أحد إلى أين يمكن أن يقودنا؟
مقالات الرأي لا تعبر بالضرورة عن “زاوية ثالثة”