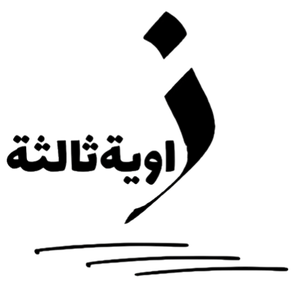أيام قليلة وينتهي استحقاق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ويُعلن رئيس مصر القادم. ويبدو الخبر من الوهلة الأولى معروفًا مسبقًا دون الحاجة إلى إثبات صناديق الانتخابات سواء على المراقب السياسي والإعلامي أو على المواطن العادي، رغم ذلك ترتبط شرعية السلطة بإجراءات الشكلية القانونية، خاصة لوجود رغبة في عدم تكرار سيناريو انتخابات 2018، لأسباب عديدة في قلبها الأزمة الاقتصادية. لذا فإن افتراض شكلية التنافس الذي هو أبجدية لأي عملية اقتراع ديمقراطي، اعتبر مدخلًا لفتح المجال العام نسبيًا، خاصة مع التجهيز له عبر طاولة “الحوار الوطني” الذي يعد كما أشرت في مقال سابق “إجراء متبعًا في بنية الدولة الوطنية في إقرار السيادة والشرعية الرمزية بعد انتهاء صلاحية الحالة الاستثنائية، لذا كان الحوار الوطني تأسيسًا في رحاب طريق الجمهورية الجديدة”.
إلا أن الحجر الذي ألقاه المرشح المحتمل السابق “أحمد الطنطاوي” من خارج قبة الحوار الوطني، عندما أعلن الدخول إلى المشهد الانتخابي كبديل سياسي للتحول الديمقراطي، في محاولة الضغط الشعبي لضمانة وجود عملية انتخابات جادة ونزيهة، كان كفيلًا بإظهار عملية الهندسة السياسية للمجال العام، حيث جاءت الانتهاكات بحسب “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان“؛ ممنهجة من “مؤسسات الدولة التنفيذية وأحزاب الموالاة، من استعمال المال السياسي والرشوة الاجتماعية”.
تنعكس مؤشرات غياب المتابعة والإهتمام للإنتخابات الرئاسية والتي يسهل إستقراءها ورصدها في الحياة اليومية والتي قد تصل إلى حد التفاجئ من إقتراب موعد الإقتراع. بالأخص مع تغطية أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة على المناخ العام وإرتباطها بالوجدان الشعبي وبالشأن الأمن القومي المصري، إلا أنه بالرغم من إعلان “حملة المرشح عبد الفتاح السيسي“؛ “توجيها صريحا من مرشحها بتخفيض الدعاية الانتخابية لحدودها الدنيا” لصالح أهل غزة، إلا أن ما شهدته الفضاءات الإعلانية من إنتشار “الصورة” الانتخابية بشكل واسع وغزير وكأنها تتحدث بلسان الروائي الإنجليزي “جورج أوريل”: الأخ الكبير يراقبك! لذا نطرح التساؤلات الآتية؛ لماذا كان الإصرار على هيمنة اللوحات الدعائية؟ وما الذي تخبرنا به “الصورة” عن المجتمع والمال والسياسة؟ وكيف رسمت “الصورة” الانتخابية خريطة الحياة السياسية بعد الانتخابات؟
عصر الصورة: توليد السلطة الرمزية
باتت الصورة وسيطًا ثقافيًا وأيديولوجيا هامًا، حتى أطلقت عدة مقولات مثل “عصر الصورة” و”حضارة الصورة”، لا سيما مع الحياة الرقمية المعاصرة، وعلاوة على توغلها عبر “أجهزة الدولة الأيديولوجية” تبعا لمفهوم الفيلسوف الفرنسي “لويس ألتوسير” حيث تكون التنشئة الاجتماعية على قيم الدولة وهيمنتها عبر المؤسسات من العائلة إلى التعليم وصولا للمؤسسات الدينية والأهلية والإعلامية.. إلخ.
إلا أن “الصورة” بلاغةً ومجازًا سياسيًا، بحسب المفكر السياسي “عمار علي حسن” في كتابه “المجاز السياسي”؛ تتجاوز التعبير عن الواقع، إنما تدخل المعاني والدلالات التي تحملها إلى حيز المجاز.
هنا تبدو الصورة الانتخابية ذات معانٍ سياسية مباشرة تخص الدعاية الحصرية للانتخابات، لكن الأمر يبدو أبعد من تلك القراءة الواحدة، حيث إن حصار الصورة لمرشح السلطة التي ملأت الحوائط الدعائية الضخمة على الطرق الرئيسية والكباري وفي المدن الكبرى والجديدة بالأخص، حيث تلك الفضاءات ظلت مخصصة طوال الوقت لتسويق مشاريع المطورين العقاريين والعلامات التجارية الكبرى، لكن عبرها أيضًا تُسوق الصورة عبر العملية الانتخابية مع كلمات مثل “طريق العزة واحد” “كلنا معاك” “حبيب المصريين” وهكذا تحولت من مجرد إعلانات خارجية في الشوارع، إلى حالة ترويج لمشروع الدولة بقيادة المرشح الحالي كمجاز على الهيمنة السياسية الكاملة.

إذ تعزز الصورة بأحجامها المختلفة وانتشارها الواسع المكرر، فكرة تستحوذ على مداركنا اللا واعية قوامها يكمن في تهيئة الصورة الذهنية إلى عبارة مفادها أنه لا يوجد أحد سواه يكمل الطريق، وأن الاختيار لا يجد من هو أجدر منه. وعلى الرغم من وجود بعض اللافتات القليلة نسبيا للمرشحين الآخرين والذين قد يكونوا مجهولين لقطاعات واسعة من الناس، إلا أن وجودهم الهامشي يرسخ الفكرة وتلك الصورة الذهنية التي تثبط النفس الاجتماعية المغتربة سياسيًا نحو الرضوخ الطوعي، هكذا يتراءى للهندسة السياسية التي تعمل على تثبيت دعائم الشرعية عبر المقولات وتركيز الصورة في الخيال والحس المشترك.
في دروس “كوليج دو فرنس” يشير عالم الاجتماع الفرنسي “بيير بورديو” إلى سمة السلطة الرمزية كونها؛ “سلطة لا مرئية ولا يمكن أن تمارس إلا بتواطؤ أولئك الذين يأبون الاعتراف بأنهم يخضعون لها بل ويمارسونها”.
هنا يبدو العنف الرمزي أكثر حيوية على العلاقات الاجتماعية في اختراق البنيات الشعورية والمعرفية وتدجين المجتمع على التواطؤ والتماهي وتطبيع الفرد بالشعور بالدونية مما يسهل الأمر لبسط مشروعية العنف المادي للنظام، الذي يسعى للتأكيد في اللغة والصورة والإجراءات على تطابق مفهومي النظام والدولة. هكذا تلعب الصورة أدوارًا أعمق في استمرار المخيال السياسي للاستبداد عبر خلق فضاء الصورة في التخطيط المعماري للطرق والمدن ليصبح مسارًا إجباريًا مشيدًا في الصورة البصرية والذهنية معًا.
الشبكة الزبونية: كيف تؤطِّر “الصورة” مستقبل الوطن؟
الصورة الانتخابية ككل ليست بالطبع مجرد مساحة إعلانية ممتدة دون إطار واضح لها، يرسم الأبعاد والحدود، بل إن أحد مهام الصورة الأعم للمشهد الانتخابي الذي يدور حول ظاهرة “التصويت الاحتفالي” قبل الإعلان عن الفوز الساحق للانتصار السياسي بالشعارات الوطنية، وبقاء هيمنة الصورة على الجدران وفي الشوارع ووقت المناسبات، هو نمط المراقبة الخفية دون مراقب، كأن الصورة تعلب دور فكرة “بانوبتيكون” للفيلسوف الإنجليزي “جيرمي بنثام”؛ التي تقوم على مراقبة الجميع في نفس الوقت دون أن يعرف الناس أنهم مراقبون، بل ربما تخترق فكرة المراقبة العقل الاجتماعي لتتحول إلى رقابة ذاتية في المجتمع ومؤسسات الدولة في تجلي هيبة صورة الرئيس في كل مكان.

بيد أن ما وراء الصورة المراقِبة أيضًا تتمثل الوظيفة الزبونية، حيث إن مفهوم “الزبونية السياسية” هو الذي يقوم على الروابط والعلاقات الاجتماعية حيث تمثل شبكة مصالح تقوم على الرعاية السياسية مقابل المصالح بشكل مباشر أو ضمني ودائمًا ما تظهر “الصورة” كإعلان للدعم السياسي أيضًا، والذي قد نرصد انتشارها تبعًا للموقع الطبقي، حيث إن صورة اللوحات الإعلانية الكبيرة والمكلفة ماديًا تشير إلى “المحاسيب الجدد” للسلطة في علاقتهم الزبونية معها عبر أحزاب الموالاة المكونة من شبكة عضوية لرجال أعمال وزبائن.
يشير الأنثروبولوجي الاقتصادي “كارل بولانيي” في كتابه الموسوم “التحول الكبير” إلى أن الأنساق الاقتصادية هي جزء من علاقات اجتماعية أوسع، وتلك النظرة قد تجلي لنا مشهد ما تعبر عنه “الصورة” حول البنى الاجتماعية التي تمثل قاعدة الدعم المادي والرمزي للسلطة، حيث تعتمد قاعدة العلاقات الاجتماعية الرأسمالية للفاعلين “المحاسيب” على روابط عديدة من العائلة والأسر الممتدة والطوائف الدينية ومعارف الأحياء والأصدقاء إلى العلاقات السياسية.
فبينما تعلن الصورة الولاء للسلطة وبالتالي المصلحة الاقتصادية للمحاسيب، إلا أنها تلعب دورًا مختلفا نسبيًا في اللافتات الصغيرة والمتوسطة رخيصة الثمن في الأحياء الشعبية والمدن القديمة حيث تمثل حاضنة من الطبقة الوسطى والرأسمال الأدنى التي تتماهى مع الموجه كي تفتح مسارات للعلاقات التي تمنحها مميزات ضمنية كالتفاوض الزبوني على سبيل المثال مع إدارة المرافق مع التعديات، أو التقارب مع بعض رجال الأعمال المسيسين في سبيل حجز الأولوية في الخدمات والمعارف، في حين أن صورة المرشح الرئاسي تُذكر الفقراء المعدمين بموسم رزق وحصاد متمثل في خدمات ومساعدات مثل كراتين الأغذية أو نقود الانتخابات.
ولا تظهر الصورة فقط في إطار الاستحقاق الانتخابي بل تظل حاضرة ومتصلة في الخدمات الأهلية والحزبية لتلك القطاعات الفقيرة والتي يستغل عوزها بالتعبئة السياسية والانتخابية عن طريق شبكة مصالح رجال الأعمال السياسة والتي قامت بدورها بملء الفجوة التي أحدثها تراجع الدور الأهلي والخدمي لحركات الإسلام السياسي.
بناء تلك القاعدة الاجتماعية عبر تسيس رجال الأعمال في شبكة مصالح خاضعة لسيطرة وتوجيه البيروقراطية الحاكمة للمشاريع القومية والإنشائية، تجعل مشهد الانتخابات ككل فرصة مواتية لإثبات وإحكام السيطرة عبر شرايين وقنوات تلعب على المحسوبية والزبونية والحفاظ على المصالح القائمة، والتي أصبحت أقرب للوساطة بين الدولة والمجتمع في ظل تجريف المجتمع المدني والمناخ العام، حيث أن لغة الصورة أصبحت حلقة الإتصال والدعم السياسي والإنتماء القومي، إذ أنها غطت على أهمية الوساطة التقليدية للعمدة في القرى ومشايخ القبائل ومحافظ المدن. تبدو الصورة بتلك الطريقة معلما لطريق الدولة في المشاركة في مراكمة رأس المال والذي يعود في صالح قلة تعطي بدورها تفويضا على بياض للسلطة عبر الرأسمال الاجتماعي.
ما بعد الانتخابات: التعددية في إطار سلطوي
صورة وثلاثة أخرون…. هذه هي التعددية التي تخبرنا بها الانتخابات الرئاسية، إذ لعل ما توضحه من غلبة صورة الرئيس الحالي على صور المرشحين الأخرين لكفيل أن يجعلنا نتساءل عن وجهة السلطة، هل هي سلطوية استبدادية أم تعددية ديموقراطية؟
بيد أن محاولة فهم ما تعبر عنه هيمنة الصورة الانتخابية في الحياة السياسية فيما بعد الانتخابات، يحيلنا إلى فهم ما تؤسس عليه الصورة، إذ منذ ما بعد الحرب الباردة مع سقوط جدار برلين، سعت العديد من الأنظمة الديكتاتورية إلى التكيف مع النظام العالمي الجديد، والذي أدى بجانب العديد من العوامل الأخرى بالرئيس الأسبق “حسني مبارك” بإقامة انتخابات رئاسية عام 2005م= لأول مرة منذ إعلان الجمهورية، إذ أصبحت بجانب صورة الرئيس المعلقة في المكاتب الحكومية وفي الاحتفالات والاستفتاءات، صور مرشحين آخرين منافسين، تبدو هذه المنافسة قد تم تصميمها منذ البداية على خطى “السلطة الهجينة”، حيث أن الرئيس والمرشح الحالي لم يأت بجديد بعد الربيع العربي، إلا إعادة ترتيب البيت الداخلي والمصالح وإعادة إحياء الدولة الوطنية الهجينة.

تبدو الجمهورية الجديدة بالتعريف “سلطة هجينة” بمعنى أنها تقوم على الشرعية الديموقراطية والقانونية وتمارس إجراءات الانتخابات لكنها ديموقراطية معيبة حيث لا تقوم على الضمانات الكافية ولا على النزاهة الكاملة بحيث تقدم تعددية غير تنافسية في ظل تقييد الحريات المدنية والمساحة الإعلانية والإعلامية بطرق ممنهجة، لذا تكون مساحة المنافسة السياسية حصرا في نطاق التنافس بين أحزاب الموالاة والنخب السياسية في نفس الدائرة التي تسيطر عليها مجموعة واحدة، تجعل تداول السلطة أمرًا شبه مستحيل، لذلك تكون صناعة “الصورة” علامة على السلطة الهجينة التي تجعل منها تقليد ساريًا بصريًا ودلاليا.
ربما أبرز ما شكّل تلك التعددية المحدودة هو اعتماد النظام الحاكم على الطبقة الرأسمالية الموالية كما سلف وأشرنا، حيث جاءت تلك الحاجة بشكل أكثر إلحاحًا، منذ عصر مبارك، فبحسب أستاذ الاقتصاد السياسي “سامر سليمان” في كتابه ”النظام القوي والدولة الضعيفة”، أن نظام مبارك اعتمد على المال والخدمات في شراء التأييد السياسي، لكن تناقص إيرادات الدولة عكس تدهور “القوة الشرائية السياسية”، لذا كان التعويض في زيادة تدخل القوة الشرائية لرجال الأعمال.
وقد كانت المشاركة السياسية للرأسمالية المصرية أكثر إلفاتًا في سياسات حكومة أحمد نظيف ومشروع توريث جمال مبارك، إلا أن نظام 3 يوليو 2013م قد أعاد تشكيل مساحة البرجوازية، وحدد مجال صعود روافد برجوازية متوسطة جديدة تبعا لشبكة المصالح ومحسوبية الجديدة داخل إطار أحزاب الموالاة بشكل مباشر أو غير مباشر، كي تدفع بمشاريع السلطة المكثفة للجمهورية الجديدة.
تشير بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تراجع الشعبية لمرشح السلطة الحالي مع سياسات الحكومة التي تعتمد على الاقتراض والمديونية لتشييد مشاريع كبرى، في المقابل يعصف سعر الصرف الدولاري يوميًا بالقوة الشرائية للسلع الغذائية الأساسية ومنتجات الطاقة وغيرها، لذا فما ترتبه لنا مظاهر “الصورة” الانتخابية، هو بصيص من التراجع السياسي المحدود، من توفير هامش من التحرك في المجال العام في ظل الأزمة الاقتصادية المتصاعدة، حيث يأتي دافع حاجة السلطة إلى أدوات مختلفة للتعامل مع الأوضاع شديدة السوء، فمنذ الحوار الوطني، حدد سقف العمل السياسي والحزبي كما مثلته استمرار مراقبة صورة “الأخ الكبير” على طريقة الانتشار، كالتالي أحزاب الموالاة، الأحزاب الكرتونية، الأحزاب المعارضة داخل الحوار الوطني.