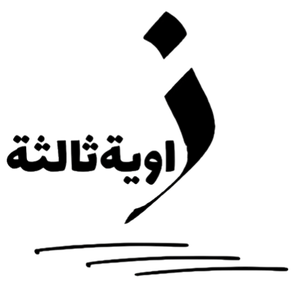في الثالث من أبريل، يبدأ الرئيس المصريّ، عبد الفتّاح السيسي، فترة ولاية جديدة، هي الثالثة فعليًّا، والثانية بموجب التعديل الّذي أدخله مجلس النوّاب، في 16 أبريل 2019، على نصّ المادّة 140 من دستور 2014، والّذي شمل تمديد فترة ولاية رئيس الجمهوريّة من أربع سنوات إلى ستّ سنوات، تسري على فترة الولاية الثانية للرئيس السيسي الّتي بدأت في عام 2018، والسماح له بالترشّح، بعد انتهائها، لفترة جديدة مدّتها ستّ سنوات، الأمر الّذي يتيح له البقاء في المنصب حتّى 2030. وانتخب السيسي رئيسًا للجمهوريّة، لأوّل مرّة، في عام 2014، وأعيد انتخابه لفترة ولاية ثانية في عام 2018، وفاز بأغلبيّة ساحقة ومضمونة بعد انتخابات رئاسيّة أجريت نهاية العام الماضي. واستوفت هذه الانتخابات جميعًا شروط الانتخابات الديمقراطيّة، من حيث الشكل، إذ خاضها أمامه مرشّحون يمثّلون أحزابًا معارضة، لكنّها أثارت علامة استفهام كبيرة بخصوص طابعها التنافسيّ، والّذي يعدّ شرطًا جوهريًّا للإقرار بأنّها انتخابات ديمقراطيّة، فضلًا عن الجدل الّذي ثار حول ملابسات التعديل الدستوريّ الّذي أجريت الانتخابات الأخيرة بموجبه.
من حيث الشكل والإجراءات أيضًا، استوفت التعديلات الدستوريّة، الّتي اشتملت على بنود تخصّ مدّة الرئاسة، الشروط الّتي تضمن سلامتها، إذ حظيت بتأييد أغلبيّة ثلثي أعضاء مجلس النوّاب، إذ وافق عليها 531 عضوًا من إجماليّ 554 عضوًا حضروا جلسة التصويت النهائيّة، بينما رفضها 22 عضوًا، وامتنع عضو واحد فقط عن التصويت، كما حظيت بموافقة أغلبيّة الناخبين بعد طرحها لاستفتاء عام أواخر أبريل 2019، غير أنّ السياق الّذي أقرّت خلاله هذه التعديلات والمبرّرات الّتي سيّقت لتسويغها، تثير نقاشًا حول استمرار تأجيل الاستحقاقات الديمقراطيّة الّتي تتطلّع إليها قوى سياسيّة واجتماعيّة داخل مصر. كذلك، تثير سوابق التعديلات الدستوريّة فيما يخصّ “مدد” الرئاسة مخاوف كثير من المراقبين الّذين لا يستبعدون إجراء تعديل دستوريّ آخر يضمن للرئيس الحاليّ شغل المنصب لمدد غير محدودة، ممّا يغلق الباب، لأجل غير مسمّى، أمام إمكانيّة إحداث تغيير سياسيّ عبر الانتخابات، الأمر الّذي ينعكس سلبًا على فرص تحقيق انتقال ديمقراطيّ في مصر في السنوات الستّ القادمة، خصوصًا أنّ التطوّرات الإقليميّة والدوليّة ترجّح أن يحظى الاستقرار بالأولويّة وباهتمام وتركيز القوى الدوليّة والإقليميّة الداعمة والمؤثّرة، لاسيّما مع تراجع حماسها لمسألة الديمقراطيّة، بشكل عامّ، بل وتراجع إيمان هذه القوى بالديمقراطيّة كنظام أمثل للحكم قادر على التعامل مع الأزمات والتحدّيات، الّتي تواجهها كثير من الدول في العالم.
نرشح لك: لماذا لا تغرق مصر في ديونها؟
![]()
الانتقال إلى الديمقراطية مأزوم أم محتجز
وفرت التطورات في السنوات اللاحقة على ثورة 25 يناير 2011، فرصة لاختبار الفرضيات التي قامت عليها فرضية أن الانتقال الديمقراطي في مصر محتجز، والتي طرحها المفكر المصري الراحل، محمد السيد سعيد في كتابه الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عام 2006، بعنوان “التحول الديمقراطي المحتجز في مصر“، والتي يوافق عليها كثير من المراقبين للوضع في مصر، وتتبناها دوائر داخل النخبة الحاكمة، التي لا تزال مصرة فيما يبدو على رؤيتها بأن الشعب لم ينضج بعد، لينال الديمقراطية لاسيما بعد تجربة الانتخابات البرلمانية في عام 2011، والرئاسية في عام 2012، وما أسفرت عنه من أزمات متلاحقة، أدت إلى احتجاجات واسعة في عام منتصف عام 2013، انتهت بالإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين وبالرئيس المنتخب المنتمي للجماعة. ورسخت هذه التجربة في أذهان قطاعات أوسع من النخبة، والجمهور العام، أن الشعب غير مؤهل بعد للديمقراطية، نظراً لافتقار الوضع السياسي إلى آليات كافية لهذا التحول الديمقراطي بسبب غياب المجتمع، بصورة شبه تامة، عن الهم السياسي وضعف منظمات المجتمع المدني والانكماش المذهل لحجم النخبة السياسية وتراجع نشاطها، وهامشية وتبعية الطبقة المثقفة، لا سيما الطبقة المشتغلة بالسياسة، وهي عوامل تؤدي جميعها إلى افتقاد قوة الدفع الضرورية للانتقال إلى الديمقراطية.
إن المبررات التي قدمها عدد من الكتَّاب والمثقفين لإجراء هذه التعديلات، والتي تكشف القلق والخوف من النتائج التي قد تترتب على تغيير رأس السلطة، ولو عن طريق الانتخابات، على الاستقرار وكأن تحقيق هذا الاستقرار مرهون ببقاء الرئيس في السلطة مدى الحياة، وتتصور أن انتخاب رئيس آخر يتضمن مخاطر وأضراراً اقتصادية وأمنية تستهدف تقويض الدولة، والأخطر أن هذه المبررات، والتعديلات التي أقرت، تعكس قناعة راسخة لدى الحكومة، وربما لدى قطاعات أوسع بين المثقفين والجمهور العام بأن البلاد ليست مهيأة لإجراء إصلاحات سياسية واسعة يمكن أن تؤدي إلى انتخابات عامة على كافة المستويات، تضمن تمثيلاً حقيقيا، وتؤدي إلى إدخال تعديلات على قواعد اللعبة السياسية، رغم اليقين بحاجة البلاد إلى إصلاحات سياسية، وأنها قد تكون ضرورية لتوفير آليات تمنع حدوث انفجارات اجتماعية وسياسية خارجة عن السيطرة. وتكمن المفارقة في استمرار عدم مواكبة الوضع السياسي للإصلاحات التي يجري تنفيذها لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصادية، وربما يرجع السبب في ذلك أن تلك الإصلاحات وما يترتب عليها من تغييرات اجتماعية جذرية تنال من استقرار ورفاهية قطاعات واسعة من المجتمع، تتضرر من هذه السياسات. إن إدراك السلطة في مصر لهذه الحقيقة هو السبب الرئيسي لاعتقادها بوجود جهات متربصة يمكنها استثمار الحراك السياسي لخدمة أهدافها، وقناعتها الراسخة بأن الانفتاح السياسي الواسع يمثل خطرا على المجتمع والدولة، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي تعكسه مستويات الفقر.
| إذ تشير تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تزايد نسبة السكان تحت خطر الفقر وارتفاع الحد الأدنى للفقر؛ بسبب المستويات القياسية للتضخم وتراجع قيمة العملة، فضلًا عن تدهور مستويات التعليم والأمية، وهي عوامل تسهل إمكانية التلاعب بالعملية الديمقراطية والانتخابات، وتعتمد السلطة على قمع المعارضة السياسية والاحتجاجات المجتمعية، عبر آليات أمنية. |
وتشير هذه التحوّلات إلى أنّنا أمام أزمة بنائيّة تعانيها عمليّة التحوّل الديمقراطيّ تشمل النخبة الحاكمة والمعارضة السياسيّة، ولسنا أمام احتجاز للعمليّة من قبل السلطة فقط. وتتجلّى هذه الأزمة البنائيّة في حالة الضعف الشديد الّذي تعانيها الأحزاب السياسيّة في مصر بشكل عامّ، وأحزاب المعارضة بشكل خاص، وعجزها عن إيجاد حلول وطرح تصوّرات يحتاج تحقيقها إلى الإرادة السياسيّة للسلطة، وعدم قدرتها على إقناع السلطة بخطورة استمرار الأوضاع والسياسات الراهنة على الاستقرار، وافتقارها إلى أدوات لتصعيد الضغط الجماهيريّ على السلطة، وإلى أدوات التواصل الجماهيريّ والحشد لسياساتها وبرامجها، فضلًا عن افتقارها للتطوّر المؤسّسيّ الّذي يعكس تدنّي مستوى الخبرة في الممارسة السياسيّة. كذلك، فإنّ قياسات الرأي العامّ الّتي تجريها الحكومة والأجهزة المختلفة من وقت إلى آخر تأتي مطمئنّة لها، إذ تثبت اقتناع قطاعات واسعة من الجمهور بعدم جدوى الديمقراطيّة، وارتباطها المباشر بتوفير الاحتياجات الأساسيّة للمواطنين، من متطلّبات معيشيّة والأمن والاستقرار.
يفاقم من هذه الأزمة تطوّرات إقليميّة ودوليّة تعلي من أهمّيّة ضمان الاستقرار على حساب الضغوط من أجل الإصلاحات السياسيّة الديمقراطيّة، والدخول في عمليّة تفاوض وضغوط مباشرة للحصول على ضمانات تحقّق مصالح القوى الخارجيّة الإقليميّة والدوليّة من خلال الحكومات، والّتي قد تكون على حساب قطاعات اجتماعيّة وقوى اقتصاديّة محلّيّة. وتكشف التطوّرات اللاحقة خلال الأشهر الستّة الأخيرة حقيقة أن الثابت الوحيد في نهج الولايات المتّحدة وحلفائها الأوروبّيّين، هو الاستعداد للعمل مع أيّ جهة في مصر تكون في السلطة، لأنّ لديها مصالح قويّة في مصر، والشراكة الأمنيّة الّتي تعدّ أساسيّة لمواجهة المتطرّفين العنيفين ولاحتواء إيران.
ويعدّ السلام بين مصر وإسرائيل حجر أساس للأمن الإقليميّ والإسرائيليّ من دون شكّ. فعلى الرغم من تعاقب القيادات على السلطة في مصر، منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، إلّا أنّ هذه القيادات حاولت منح الامتيازات لحلفاء مصر واحتواء أعدائها أو استبعادهم. ينتهي الأمر بدعم أيّ رئيس قادر على إرساء الأمن والاستقرار والحيلولة دون انزلاق البلاد إلى الفوضى.
نرشح لك: هتافٌ ولحيةٌ وبيادة.. لماذا تحوّلتْ الثورةُ إلى شبحٍ يُطاردُ الجمهوريةَ الجديدة؟
![]()
الديمقراطيّة والاستقرار
ثمّة تحوّلات جذريّة جرت في بنية النظم السياسيّة الّتي امتلك أدوات جديدة لفرض السيطرة والرقابة على المواطنين بتكلفة أقلّ، غيّرت من طبيعة الاستقرار السياسيّ الّذي يقوم على ركيزتين أساسيّتين، هما: فرض السيطرة والإرغام والرضا، والّتي كانت تعني أنّ النظام المفتوح والتعدّديّ وحده هو النظام الّذي من شأنه أن جمع المواطنين ودفعهم لاتّخاذ قرارات كبيرة وجسورة من أجل الإصلاح السياسيّ والاقتصاديّ، وأنّ الاستقرار يتأثّر في حالة اختلال أيّ من هاتين الركيزتين. ومن شأن التركيز على هاتين الركيزتين، أن ينقل النقاش حول مسألة الديمقراطيّة، ويعيد التفكير في معناها وأهمّيّتها، ولا يختزلها في عمليّة الانتخابات، رغم أهمّيّتها المحوريّة بالنسبة للديمقراطيّة الّتي تعني في التحليل الأخير، انتقال السلطة بشكل سلميّ ودون إراقة للدماء، ذلك لأنّ الديمقراطيّة تصبح آليّة أساسيّة لتنظيم التنافس أو الصراع على السلطة، من خلال ردّ السيادة إلى صاحبها الحقيقيّ، الشعب الّذي تعبّر عنه هيئته الانتخابيّة بشكل دوريّ ليفوّض من يرى أنّه الأصلح لإدارة شؤونه بموجب تفويض مقيّد الصلاحيّة ومحدّد زمنيًّا. ولا يمكن لهذا الأمر أن يتحقّق إلّا من خلال ترتيبات دستوريّة ترسي مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة فيما بينها، وتقييد السلطة والتوسّع في ضمانات الحرّيّات والحقوق للمواطنين، وفرض سيادة القانون الّتي تعني خضوع الجميع لسلطته.
استنادًا إلى هذه القاعدة، فإنّ اللجوء المتكرّر لتعديل الدساتير من أجل توسيع صلاحيّات السلطة التنفيذيّة على حساب السلطات الأخرى، والحدّ من الضمانات الممنوحة للمواطنين، أو تفريغ المبادئ والموادّ الدستوريّة من مضمونها عبر تسويف إصدار التشريعات الّتي تضمن تنفيذ هذه الحقوق وصيانتها أو إصدار تشريعات تتناقض مع جوهر هذه الضمانات، مثل التعديلات على مادّة الحبس الاحتياطيّ المفتوح المدّة، المادّة 143/ 3 من قانون الإجراءات الجنائيّة بشأن الحبس الاحتياطيّ، الّتي أصدرها الرئيس المصريّ السابق عدلي منصور في 23 سبتمبر 2013 والمنشور في الجريدة الرسميّة بتاريخ 27 سبتمبر 2013، يقضي بتعديل المادّة لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صدارًا بالإعدام أو السجن المؤبّد أن تأمر بحبس المتّهم احتياطيًّا لمدّة 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيّد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، في تعارض مع قرينة البراءة الّتي کفلها الدستور الحاليّ وقانون الإجراءات الجنائيّة المصريّ والتزامات مصر الدوليّة المنصوص عليها في المواثيق الدوليّة المتعلّقة بحقوق الإنسان بشأن تحديد مدّة للحبس الاحتياطيّ، وتتعارض مع الغاية منه في الدستور، علاوة على التشريعات الأخرى والتعديلات الّتي أدخلت، والّتي تقيّد حرّيّة الرأي والتعبير والتنظيم للمواطنين، والتوسّع في أسباب الحبس الاحتياطيّ، بما يخلّ بالضمانات والحماية الدستوريّة لجوهر الحرّيّة الشخصيّة، وأنّ الأصل في المتّهم البراءة.
| إنّ الافتراض القائل بأنّ ممارسة الديمقراطيّة في المجتمعات غير المؤهّلة يقوّض الاستقرار السياسيّ في هذه المجتمعات، يخفي حقيقة أنّ الاستقرار في الأساس يتحقّق من خلال احترام الدستور والالتزام بمبادئه وكذلك احترام القانون وأحكامه، وحقيقة أنّ السلطة التنفيذيّة المناط بها تنفيذ القانون والالتزام بالدستور هي المصدر الرئيسيّ لهذه الانتهاكات عندما تصطدم القرارات والإجراءات الّتي تتّخذها بحقوق أساسيّة مصونة بموجب الدستور والمواثيق والعهود الدوليّة. |
وبدلًا من الشروع في إصلاحات تشريعيّة لإصلاح الخلل، تلجأ هذه السلطة إلى استغلال اختلال توازن القوى الّذي يميل إلى صالحها لتمرير تشريعات تعصف بتلك الضمانات، وتقوّض الأساس الّذي يعمل القانون على ترسيخه وهو تحقيق العدالة للمواطنين، والّذي يحقّق الاستقرار المجتمعيّ والسياسيّ، ولا تحقّق الأهداف المرجوّة من العمليّة الديمقراطيّة مثل الحرّيّة والعدل والمساواة والعدالة الاجتماعيّة والشفّافيّة والمشاركة. فالديمقراطيّة ليست غاية في ذاتها، لكنّها أفضل آليّة عرفتها البشريّة إلى الآن لتحقيق الأهداف المذكورة وغيرها من قيم أساسيّة لتحقيق الاستقرار في المجتمع.
غير أنّ الأزمة الّتي تعانيها الديمقراطيّة في ظلّ تشكّك كثير من القوى في تعبير آليّة الانتخابات والتصويت عن الإرادة الحرّة الناخبين؛ بسبب الكثير من صور وأشكال التلاعب والتحيّزات الثقافيّة والمعرفيّة الّتي توجّه نتيجته، بسبب سوء استعمال السلطة وسوء الإدارة وانتهاك الدساتير والتعدّي على الحرّيّات العامّة والخاصّة، وتهميش المواطنين والجمهور بسبب عدم المشاركة في الحياة السياسيّة، وسوء إدارة الحكم والشؤون العامّة، وأيضًا لأنّ الممارسات السياسيّة أثّرت بالسلب على مستوى المعيشة والتعليم والرعاية الصحّيّة وفرص العمل، حيث غابت الحرّيّات والأحزاب السياسيّة الحقيقيّة وألغي الشارع السياسيّ لصالح المزيد من الاستبداد وقمع الحرّيّات، تضعف إيمان الجمهور وثقته بالديمقراطيّة والميل إلى أشكال أخرى، عنيفة غالبًا، للتعبير عن الرفض والاستياء.
وطرح الباحثان فرانك كارستن وكارل بيكمان، هذه الإشكاليّة من خلال الكتاب التعريفيّ بمشروع “ما وراء الديمقراطيّة”، إذ طرحا التساؤل: لماذا لا تؤدّي الديمقراطيّة إلى الوحدة والرفاهية والحرّيّة، بل تؤدّي إلى عدم الاستقرار وعدم خضوع الإنفاق العامّ للرقابة والسيطرة، والتوسّع في نمط الحكم الاستبداديّ، النقيض الواضح للحكم الديمقراطيّ والمساءلة. ولا شكّ في أنّ الاتّجاه العامّ المتنامي للتشكيك في الديمقراطيّة ورفضها كأسلوب أفضل للحكم، بل كراهيتها، من المرجّح أن تشجّع النظام الحاليّ في مصر على المضيّ قدمًا في الأساليب المعتمدة والمجرّبة لإدارة الحكم في مصر، يساعده على ذلك المشكلات المتزايدة الّتي تعانيها الدول الديمقراطيّة بشكل عامّ، بما في ذلك الديمقراطيّات العريقة والراسخة، والّتي من بينها تهميش المواطنين، وتدنّي نسب المشاركة في الحياة العامّة، وانخفاض العضويّة في الأحزاب السياسيّة والفساد، وما يصاحب ذلك من تغليب قرارات الحكّام على اختيارات الشعوب، والّذي تتداخل فيه قوى خارجيّة تتمتّع بنفوذ مثلما حدث في التعامل مع الأزمة الاقتصاديّة الأخيرة في اليونان، وتعامل النظم الديمقراطيّة الغربيّة مع قضايا السياسات الخارجيّة، مثل الموقف من العدوان الإسرائيليّ على المدنيّين الفلسطينيّين في غزّة، ومن قبلها قضيّة غزو العراق، الأمر الّذي أدّى إلى فقدان الثقة بالديمقراطيّة، فضلًا عن بروز طائفة جديدة من القضايا، مثل العلاقة بين الاقتصاد والحوكمة، التغيّر المناخيّ وإدارة الموارد الطبيعيّة، وتعامل بعض الدول مع الإرهاب بطرق لا تحترم مبادئ الديمقراطيّة الأساسيّة، والّتي تطرح إشكاليّة التفاوت الكبير القائم بين المثال الديمقراطيّ، الّذي تطوّر في بيئات سياسيّة واجتماعيّة متباينة، وبين سياسة وممارسات وأداء النظم الديمقراطيّة.
قد يكون من الصعب تصوّر أن تمضي وفق تجربة التطوّر الديمقراطيّ في مصر وفق المثال الأوروبّيّ الّذي يرى أنّ الديمقراطيّة المتمثّل في تحقيق المساواة وحقوق الإنسان والسلام، الّتي مكّنت الشعوب الأوروبّيّة من إعادة بناء مجتمعاتها بعد حربين عالميّتين، لكن يتعيّن عليها أن تقطع خطوات لتوفير الشروط الضروريّة كي يكون من الممكن الحديث عن مستقبل ديمقراطيّ، سواء في الفترة المتبقّية من حكم السيسي وفق الدستور الحاليّ، أو في ظلّ أيّ تطوّر سياسيّ آخر.
| ويتعيّن على الأطراف المنخرطة في النظام السياسيّ المصريّ على مستوى الأحزاب والمؤسّسات والنخبة الاستراتيجيّة والنخب المتنافسة والمتصارعة، أن تعمل على إعادة صياغة العقد الاجتماعيّ بعد تحلّل العقد الاجتماعيّ الّذي قام خلال العقود الماضية، في العديد من الدول بين الحاكم والمحكوم كأمر واقع، والّذي تولّت بموجبه الأنظمة الاستبداديّة والشموليّة الحكم، وحقّقت الاستقرار الاقتصاديّ على حساب الإصلاحات البنيويّة العميقة، والاستقرار الأمنيّ على حساب الحرّيّات والحقوق. |
ذلك لأنّ تفاقم مستويات البطالة أدّى إلى المزيد من الفساد المستشري واليأس بين الشباب وانسداد الأفق، مع انعدام المبادرات الفعّالة للخروج من المأزق، مع إدراك أنّ هذا الاستقرار الهشّ لا يوفّر سبل الحياة الكريمة، ويؤدّي إلى التهميش والمنع من المشاركة.
لا بدّ من وصول النظام إلى الإقرار بأنّ استمرار الصيغة الراهنة في الحكم وما يترافق معه من تحوّلات نتيجة لاختلاط الأمور السياسيّة بالدين، واللجوء إلى العنف الّذي يأخذ أبعادًا إرهابيّة خطيرة، وتراكم المشكلات السياسيّة والاجتماعيّة، وزيادة حدّة انسداد أفق التغيير والإصلاح وتراجع الثقة بالمستقبل خاصّة لدى الشباب، وجميعها أمور تزيد حدّة التدخّلات الأجنبيّة والإقليميّة، ووصوله إلى هذا هو الشرط الضروريّ من أجل الشروع في عمليّة للإصلاح السياسيّ تؤدّي إلى فتح المجال لحصول انتقال إلى الديمقراطيّة يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصاديّ وما تفرزه من تغيّرات جذريّة.
نرشح لك: عن السلطة الفلسطينية وجدوى المقاومة.. رحلة في عقل مريد البرغوثي
مقالات الرأي لا تعبّر عن زاوية ثالثة